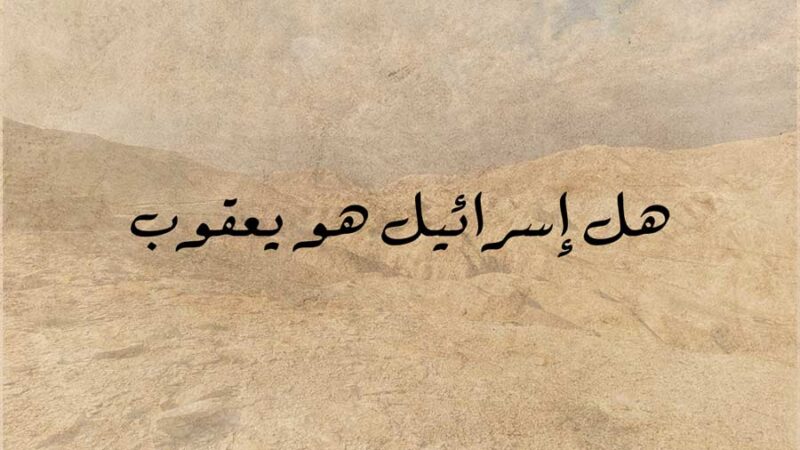تفسير سورة الفلق

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ، ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓ
(ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ) [النور: 35].. فلا نور إلاّ من الله تعالى.. وكتاب الله تعالى وُصف بالنور(فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ) [الأعراف: 157]، وبالتالي فالصلة مع الله تعالى تكون بإتّباع نور كتابه الكريم..
.. والنور لا يجتمع مع الظلام، كون الظلام ليس أكثر من دليل على عدم وجود النور، وبالتالي فأيّ محاولة لفهم آيات كتاب اله تعالى بأدوات تاريخيّة أقل – بالتأكيد – من كتاب الله تعالى، هي محاولة لإبعاد النفس عن النور، وبالتالي هي محاولة نتيجتها تيه النفس في دياجير الظلام..
.. تفسير آيات كتاب الله تعالى من منظار نور كتاب الله تعالى ذاته، ضرورة لا بدّ منها، لصبغ النفس بنور كتاب الله تعالى، وإلاّ فستهبط النفس فكراً وثقافة واعتقاداً أكثر في مستنقعات ظلمات الأهواء والعصبيات..
.. في هذا البحث سنتناول تفسير سورة الفلق، وهي من السور القصيرة، والتي يحفظها معظم المسلمين، ويتباركون بها، ويضعونها في منازلهم، لنرى كيف أنَّ منهجية تفسير آيات كتاب الله تعالى بمعايير قرآنيّة من المقدمات إلى النتائج، توصلنا إلى الوقوف على حقيقة ما تحمله آيات كتاب الله تعالى من دلالات..
(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) [الفلق: 1 – 5]
.. السورة الكريمة تبدأ بكلمة (قُلۡ)، وهي أمرٌ من الله تعالى لرسوله ومن بعده لكلِّ إنسانٍ مؤمنٍ بكتاب الله تعالى، بأن يقول كلمات هذه السورة الكريمة..
.. وكلمة (أَعُوذُ)، من الجذر: (ع، و، ذ)، حيث دلالاته تدور في إطار الاستجارة والاحتماء واللجوء والاعتصام، فكلمة (أَعُوذُ) بمعنى: أستجير وألوذ وأحتمي وألجأ وأعتصم.. والاستعاذة تتكوَّن من ثلاثة عناصر :
أ – مُستعيذ، وهو من يَطلب الاحتماء واللجوء والاعتصام، وهو هنا المخاطب بكلمة: (قُلۡ)..
ب – ومن مُستعاذ به، وهو هنا الله سبحانه وتعالى، الآمر بهذه الاستعاذة عبر كلمة: (قُلۡ)، وبحيثيّة الربوبيّة المتعلَّقة بالفلق: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)..
ج – ومن مُستعاذ منه، حيث يطلب المستعيذ الاحتماء بالمستعاذ به خوفاً من المستعاذ منه، وهو هنا أربعة عناصر كما تبيّن لنا هذه السورة الكريمة :
1 – (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)
2 – (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)
3 – (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ)
4 – (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)
.. الله تعالى في هذه السورة يأمر الإنسان بأن يستعيذ بـ (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، فماذا تعني كلمة: (ٱلۡفَلَقِ) ؟.. هذه الكلمة من الجذر (ف، ل، ق)، ولهذا الجذر في كتاب الله تعالى أربعة مشتقات، هي هذه الكلمة التي نحن بصدد دراستها، وثلاثة مشتقات في النصين التاليين..
(إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتِ مِنَ ٱلۡحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ ٩٥ فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنًا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ حُسۡبَانًا ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ) [الأنعام: 95 – 96]
(فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ) [الشعراء: 63]
ومشتقات الجذر (ف، ل، ق)، تدور في إطار الشق والتمايز، فانفلق الشيء يعني: انشق وتمايز وانفصل إلى فِرْقَين، مجموعهما هو هذا الشيء في هيئة جديدة، بمعنى: خروج حالة جديدة من حالة سابقة.. وهذا ما ينطق به قوله تعالى :
(فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ) [الشعراء: 63]
.. فنتيجة لضرب موسى للبحر بعصاه، انشق وتمايز وانفصل إلى فِرْقَين (فَٱنفَلَقَ).. بمعنى: نتجت حالة جديدة للبحر عن حالته السابقة، تمايز بها نتيجة انشقاقه إلى فِرْقَين.. وهذا المعنى نراه في اسم الفاعل (فَالِقُ) ، سواءٌ للحبِّ والنَّوى، أم للإصباح.. فالعبارة: (فَالِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ)، تبيّن فعل الله تعالى المستمر بشقِّ الحبِّ والنوى وتمايزه وانفصاله، وذلك لإنتاج حالة جديدة من الحياة نتيجة هذا الانشقاق والتمايز..
.. والحبُّ والنوى ذاته خلقه الله تعالى نتيجة انشقاق مكوِّنات النبات الذي نتج منه، ونتيجة تمايز في مكوّناتها، ونتيجة تمايز مكوّناته من حالة الحياة وهو في نباته ويأخذ الغذاء منه وينمو، إلى حالة الثبات وعدم النمو وعدم التفاعل مع الوسط المحيط، وهذا أيضاً محمول بقوله تعالى: (فَالِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ)..
.. فالنبات في حالة النمو والاخضرار (حالة الحياة) ينتج الحبَّ والنوى، ليتحوَّل من حالة الاخضرار التي يتغذى بها من نباته، إلى حالة كامنة لا تنمو (حالة الموت)، حيث تخزن بحالتها هذه، سواءٌ بهدف استخدامها لاحقاً من أجل إعادة غرسها، أم بهدف الطعام، وهذه ما تصوِّره العبارة القرآنيّة في السياق التالي مباشرة، وفي ذات الآية الكريمة: (وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتِ مِنَ ٱلۡحَيِّ)..
.. وعندما تُهيَّأ (للحبِّ والنوى) الظروف المناسبة من تربة وماء وهواء، تنشقُّ وتتمايز، لتبدأ دورة الحياة لنبات حي من جديد، وهذا محمول بقوله تعالى: (فَالِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ)، وهذا ما تصوِّر حيثيّته العبارة القرآنيّة التالية مباشرة لهذه العبارة، وهي: (وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتِ مِنَ ٱلۡحَيِّ)..
.. ما بين هاتين الحركتين، حيث الله تعالى يقول: (يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتِ مِنَ ٱلۡحَيِّ).. تتمُّ عملية الفَلْق (إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ)..
.. وما دمنا في هذه الآية الكريمة، أودّ أن نقف عند حكمة الانتقال من صيغة المضارع: (يُخۡرِجُ) إلى صيغة اسم الفاعل: (وَمُخۡرِجُ) في العبارة القرآنيّة: (يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتِ مِنَ ٱلۡحَيِّ)..
.. في النصوص الأخرى نرى صيغة المضارع دون صيغة اسم الفاعل، سواء لإخراج الحي من الميّت، أم لإخراج الميّت من الحي..
(تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ) [آل عمران: 27]
(قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ) [يونس: 31]
(وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ١٨ يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَيُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخۡرَجُونَ)[الروم: 18 – 19]
.. ففي كلِّ هذه المسائل، نرى إطاراً عامّاً، لإخراج الحيِّ من الميت وإخراج الميّت من الحي، وهما أمران (ضمن هذا الإطار العام) مستمران بتفاعل أسباب حدوثهما التي يسخرها الله تعالى من أجل ذلك، لذلك نرى الصيغة الفعلية..
.. بينما في مسألة الحبِّ والنوى، نرى أنَّ اتّجاه الحب والنوى من حالة الاخضرار (الحياة) إلى حالة اليابس وعدم النمو (الموت)، تسير بشكل طبيعي دون الحاجة لتأمين شروط مناسبة من تربة وماء وهواء، فهي بكينونتها تسير بهذا الاتجاه لتصل إلى حالة اليابس والكمون وعدم التفاعل مع عناصر الحياة، دون الحاجة لفعل مستمر من أجل ذلك، ويبقى على حالته هذه حتى يتمُّ استعماله لغرس جديد، ولذلك تتجلى عظمة الصياغة القرآنيّة بورود الإخراج لهذه الحالة بصيغة اسم فاعل: (وَمُخۡرِجُ)..
.. بينما إنتاش الحب والنوى، للخروج من حالة الموت إلى حالة الحياة، بحاجة إلى عمل مستمر يتمّ فيه تأمين العناصر الضروريّة من تربة وماء وهواء، ويستمرُّ النمو مع تفاعله مع هذه العناصر، ولذلك ترد الإخراج لهذه الحالة بالصيغة الفعليّة (يُخۡرِجُ)..
(إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَمُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتِ مِنَ ٱلۡحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ) [الأنعام: 95]
.. ولمعرفة دلالات العبارة القرآنيّة (فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ)، لا بدَّ من معرفة دلالات كلمة (ٱلۡإِصۡبَاحِ)، كمشتق من الجذر (ص، ب، ح)….. والمعنى المجرّد لهذا الجذر اللغوي هو: اكتمال ضياء الشيء، فأصبح بمعنى صار وانتقل لحالٍ جديد، وأصبح الشيء بمعنى: انتقل انتقالاً كاملاً إلى حالٍ جديدٍ، ولا يعني مجرّد دخوله في وقت محدَّد هو وقت الصبح الزمني..
.. وقول تفاسيرنا الموروثة بأنَّ العبارة القرآنيّة (فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ)، تعني: فالق الظلمة بالصبح، بمعنى فالق ظلمة الإصباح بنور الإصباح، أو فالق الإصباح ببياض النهار، ليس صحيحاً، فظاهر صياغة العبارة القرآنيّة (فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ) يدلُّ على أنَّ ساحة فعل اسم الفاعل (فَالِقُ) هي (ٱلۡإِصۡبَاحِ) وليس الظلمة.. فالله تعالى هو شاقُّ الإصباح وجاعله فِرْقَين، مجموعهما في هيئتهما الجديدة، هو هذا الإصباح قبل شقّه وتمايزه.. فهذا الإصباح بفلقة يتمايز إلى فِرقين، بمعنى: بشقِّه، يكون الضياء (الصبح) في جانب من الأرض، تاركاً الظلمة في الجانب الآخر..
.. إذاً.. يأمر الله تعالى الإنسان المؤمن بكتابه الكريم (قُلۡ) بأن يستعيذ بـ (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، والفلق يصوِّر حالة الشقّ والتمايز والانفصال، وخروج حالة جديدة من حالة سابقة.. ومن المعلوم أنَّ صفة الربوبيّة (بِرَبِّ) تصف حالة التربية والعطاء والتسخير وصاحب الملك والسيِّد والمُنعم والمُدبِّر.. فالمُقسَم به (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ) هو: مالك الانفصال والشق والتمايز وولادة أيِّ حالة جديدة من حالة سابقة، ومدبّر ذلك ومُسخِّر أسبابه وراعيه والمنعم فيه، وذلك لكلِّ حالات التمايز والانفصال والتباين، التي تحصل لكلِّ الأشياء..
.. فكلُّ المخلوقات، سواء بخلقها وولادتها، أم بتمايزها وانفصالها، أو بتحوّلها من حالة لحالة، إنّما هي بذلك تتعرَّض باستمرار لما تصفه كلمة (ٱلۡفَلَقِ)، ككلمة معرَّفة بأل التعريف.. وتعرُّضها هذا لما تصفه كلمة (ٱلۡفَلَقِ)، إنّما يكون بتسخير ربِّ العالمين لذلك، وبتدبيره ورعايته والإحاطة بأسباب وقوعه..
.. إذاً.. كلُّ ما خلقه الله تعالى على مختلف أشكاله وينتمي لعالم الخلق، يتعرَّض لعملية (ٱلۡفَلَقِ) باستمرار، عبر تسخير الله تعالى لأسباب ذلك (صفة الربوبيّة)، سواءٌ كان ذلك بتمايز ولادته وتكاثره، أم بانفصاله إلى مكوّناته لإنتاج هيئة جديدة، أم بشقّه وتمايزه وتحوّله من حالة لأُخرى.. وهذا ما تبيّنه العبارة القرآنيّة المُصوِّرة للمستعاذ به: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)..
.. وفي لغة كتاب الله تعالى، هناك رابط بين حيثيّة فعل المستعاذ به (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، وبين ماهيّة المستعاذ منه.. وكنّا قد رأينا أنَّ المستعاذ منه يتكوَّن من أربعة عناصر..
1 – (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)
2 – (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)
3 – (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ)
4 – (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)
.. وكلُّ عنصر (وليس فقط العنصر الأوَّل) من هذه العناصر تتعلَّق حيثيّته بماهيّة فعل المُستعاذ به (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ).. وما نراه أنَّ الاستعاذة ليست من هذه الأشياء، وإنّما من شرِّها، فتكرار كلمة (شَرِّ) بعد كلمة (وَمِن) في كلِّ هذه العناصر ليس عبثاً..
.. وما دامت الاستعاذة هي من شرِّ كلٍّ من هذه العناصر، وليس منها بذاتها، فهذا يعني أنَّ أيَّاً من هذه العناصر له وجهان، وجه شرّ يطلب الله تعالى منّا الاستعاذة منه، ووجه خير….. ولمّا كان كلٌّ من هذه العناصر الأربعة تتعلَّق حيثيّته بفعل المستعاذ به: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، وبعد تعريفنا لدلالات كلمة (ٱلۡفَلَقِ) ورؤية خضوع كلّ ما ينتمي لعالم الخلق لفعلها، وكون حيثيّة المستعاذ منه تتعلَّق بفعل المستعاذ به.. نستنتج من كلِّ ذلك أنَّ وجهي: الشرِّ (المطلوب الاستعاذة منه)، والخير، هُما فِرْقا كلِّ عنصر من هذه العناصر الأربعة، فعملية (ٱلۡفَلَقِ) التي يتعرَّض لها باستمرار كلُّ عُنصر من هذه العناصر الأربعة، تفرقه (بالنسبة لتفاعلنا معه) إلى فِرقين، فيهما وجه شر، ووجه خير، والاستعاذة هي من وجه الشرِّ حصراً..
.. العنصر الأوَّل المطلوب الاستعاذة منه هو: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ).. وما نراه أنَّ كلمة (مَا خَلَقَ) تفيد الإطلاق، فكلُّ ما ينتمي لعالم الخلق له وجهٌ من الشرِّ (وبالتأكيد له وجهٌ من الخير)، والله تعالى يطلب منّا الاستعاذة من وجه الشَّرِّ هذا..
.. وما نراه أنَّ الفاعل لكلمة: (خَلَقَ) هو ربُّ الفلق: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ).. وأنَّ الشرَّ ليس مضافاً إلى ربِّ الفلق، وإنّما مضافٌ إلى (مَا خَلَقَ).. فالله تعالى لم يقل: (من الشرِّ الذي خلق)، إنّما يقول: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)..
.. فالشرُّ في الوجود لا يعود إلى الله تعالى، إنّما يعود للمخلوق ذاته، وحكمة الله تعالى في إيجاد المخلوقات في عالم التكليف هذا الذي نعيش فيه، اقتضت بأن يُترَكَ (لأيِّ مخلوق) وجهٌ للشرِّ يُقابل وجهَ الخير، فمن أهمِّ ميزات عالم الخلق هو الزوجيّة لكلِّ عنصر من مكوّناته..
(وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ مُّبِين) [الذاريات: 49 – 50]
.. فالشرُّ ليس بكون كلِّ شيءٍ مكوَّناً من زوجين، الشرُّ هو ما تعارض مع مصلحة الإنسان في موقفٍ مُحدَّد.. فالسخونة التي هي زوج البرودة، تكون خيراً في حالات، وتكون شرّاً في حالات أُخرى، وكذلك البرودة.. فالشرُّ ليس بزوجيّة السخونة والبرودة، الشرُّ في تعارض أيِّ منهما كاختيار لموقفٍ محدَّدٍ بعينه.. وكذلك أيُّ مكوِّن من مكوِّنات عالم الخلق، الذي خُلقَت كلُّ مكوّناته – دون استثناء – من زوجين: (وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ)..
.. وهذا الخلق لمكوّنات عالم الخلق (حيث يُمتَحَن الإنسان فيه) من زوجين (وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ)، هو دافع لأن يتذكَّر الإنسان (لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ)، وأن يبتعد في اختياره عن وجه الشرِّ ملتزماً بوجه الخير فارّاً بذلك إلى الله تعالى (فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ مُّبِين)..
.. فالشرُّ ليس مخلوقاً بذاته كشرٍّ دائم، فلربّما نحسب الشرَّ خيراً، ونحسب الخير شرّاً، فما هو خيرٌ لموقفٍ محدَّد هو ذاته شرٌّ في موقفٍ آخر، وما هو شرٌّ في موقفٍ محدَّد هو ذاته خيرٌ في موقفٍ آخر..
(وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيًۡٔا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيًۡٔا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ) [البقرة: 216]
فالشرُّ والخير مسألتان نسبيتان، لا يخرجان عن دائرة اختبار الإنسان في دار الامتحان..
(كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةً وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ) [الأنبياء: 35]
.. وحتى يوم الحساب في الآخرة هو شرٌّ لبعض الناس، وخيرٌ لبعضهم الآخر.. وحتى لذات الإنسان المؤمن الذي سيلقى ثوابه بدخول الجنّة، فيه (أعني يوم الحساب) جانبٌ من الشرِّ تمّت وقاية من سيدخلون الجنّة منه..
(إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسًا قَمۡطَرِيرًا ١٠ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمِ وَلَقَّىٰهُمۡ نَضۡرَةً وَسُرُورًا) [الإنسان: 10 – 11]
.. إذاً.. بسبب فلْقُ المخلوقات إلى فِرقين (كما رأينا) وما ينتج عن ذلك من وجهِ شرٍّ لأيِّ عنصرٍ منها نتيجة ذلك، حسب الحال النسبي للإنسان، وإحاطة هذا الشرِّ بالإنسان كونه يعيش في عالم الخلق هذا.. بسبب هذا الفلق وما ينتج عنه.. يأمر الله تعالى الإنسان، بأن يعتصم ويلجأ إلى المسخّر والراعي والمدبّر لمسألة الفلق: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، من الشرِّ الناتج عن زوجيّة وجهي الخير والشرِّ بالنسبة لأيِّ مخلوق (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)..
.. وحيثيّة الربط بين المُستعاذ به: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ) وبين المستعاذ منه: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)، باتت واضحة أمامنا، فالاستعاذة من الشرّ الناتج عن عملية الفلق للمخلوقات: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ)، تكون بالاعتصام واللجوء إلى المسخّر والمدبِّر والقيّوم على عملية الفلق هذه (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ).. فما يصيب الإنسان من شرور في عالم الخلق، يكون إمّا نتيجة الشرِّ الكائن بجوانب المخلوقات كما بيّنا، دون علم الإنسان ودون اختياره، ويكون الاعتصام منه باللجوء والاحتماء بمن يسخّر الأسباب ويدبّرها ويعطيها حيثيّات وجودها في كلِّ لحظة (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، وإمّا نتيجة الشرِّ الناتج عن مخالفة الإنسان لمنهج الله تعالى بعلم واختيار، ويكون الاحتماء من النتائج المترتّبة على ذلك، بالالتزام بمنهج الله تعالى الذي أنزله الله تعالى لمصلحة الإنسان (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)..
.. بالنتيجة نرى أنَّ العنصر الأوَّل من عناصر المُستعاذ منه: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ) يشمل كلَّ الشرور الناتجة عن عالم الخلق، فصيغة الإطلاق: (مَا) المتعلِّقة بعالم الخلق: (خَلَقَ) تشمل كلَّ مكوّنات عالم الخلق، وبالتالي فالعبارة: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ) تشمل كلَّ شرٍّ ينتج عن عالم الخلق..
.. فمن الطبيعي أنَّ المُستعاذ به هو مُسَخِّر الأسباب (عطاء ربوبيّة)، وليس الإله (عطاء الإلوهيّة)، لأنَّ كلَّ عناصر المُستعاذ منه هي في ساحة الربوبيّة (عالم الخلق) كما سنرى بإذن الله تعالى.. وكما قلنا تتعلَّق ماهيّة المستعاذ منه (وهي في عالم الخلق كعطاء ربوبيّة) بساحة فعل المستعاذ به (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، وهذا يختلف عن حالة كون المُستعاذ منه قيمة معنويّة تتعلَّق بسلب الروح والتأثير على النفس كقيمة معنويّة (غير ماديّة)، حيث يقتضي ذلك أن يكون المُستعاذ به هو الله تعالى (مقام إلوهيّة)..
(فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ) [النحل: 98]
.. العنصر الثاني من عناصر المُستعاذ منه في هذه السورة الكريمة هو: (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ).. فما هو الغاسق ؟!.. كلمة (غَاسِقٍ) من الجذر (غ، س، ق).. ولهذا الجذر أربعة مشتقّات في كتاب الله تعالى، هذا المشتق في سورة الفلق، والمشتقّات التالية..
(أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودًا) [الإسراء: 78]
(هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مََٔابٖ ٥٥ جَهَنَّمَ يَصۡلَوۡنَهَا فَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ٥٦ هَٰذَا فَلۡيَذُوقُوهُ حَمِيمٞ وَغَسَّاقٞ) [ص: 55 – 57]
(إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادًا ٢١ لِّلطَّٰغِينَ مََٔابًا ٢٢ لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابًا ٢٣ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدًا وَلَا شَرَابًا ٢٤ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ٢٥ جَزَآءً وِفَاقًا) [النبأ: 21 – 26]
.. ما نراه أنَّ كلمة: [[(غَسَّاقٞ) ،، (غَسَّاقًا)]] تُعطَف على كلمة: [[(حَمِيمٞ) ،، (حَمِيمًا)]] وذلك في وصف حال أهل جهنّم وشرابها.. وهي بذلك تصف: نقيض الصفاء، وعدم إمكانيّة الاطلاع والرؤية لحقيقة الحال والشراب، وهذا يتعلَّق بالفساد والضرر وعدم النفع..
ففي قوله تعالى (لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدًا وَلَا شَرَابًا ٢٤ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا)، نرى أنَّ كلمة: (حَمِيمًا) تقابل كلمة: (بَرۡدًا).. وأنَّ كلمة: (غَسَّاقًا) تقابل كلمة: (شَرَابًا).. ومن المعلوم أنَّ أهل الجنّة شرابهم يتَّصف بالبياض كصفة للشفافيّة والصفاء، وبالطهارة كصفة لعدم الرجس وعدم الفساد والضرر، وبالمزاج العالي..
(يُطَافُ عَلَيۡهِم بِكَأۡسٖ مِّن مَّعِينِۢ ٤٥ بَيۡضَآءَ لَذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ) [الصافات: 45 – 46]
(إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا) [الإنسان: 5]
(وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٖ وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُورًا) [الإنسان: 21]
(يُسۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ مَّخۡتُومٍ ٢٥ خِتَٰمُهُ مِسۡكٞ وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ٢٦ وَمِزَاجُهُ مِن تَسۡنِيمٍ ٢٧ عَيۡنًا يَشۡرَبُ بِهَا ٱلۡمُقَرَّبُونَ) [المطففين: 25 – 28]
.. وبالمقابل يتَّصف شراب أهل جهنّم بنقيض ذلك..
(لَهُمۡ شَرَابٞ مِّنۡ حَمِيمٖ وَعَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ) [الأنعام: 70]
(وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ شَرَابٞ مِّنۡ حَمِيمٖ وَعَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ) [يونس: 4]
(مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسۡقَىٰ مِن مَّآءٖ صَدِيدٖ ١٦ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ) [إبراهيم: 16 – 17]
(وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا) [الكهف: 29]
(فَشَٰرِبُونَ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡحَمِيمِ ٥٤ فَشَٰرِبُونَ شُرۡبَ ٱلۡهِيمِ) [الواقعة: 54 – 55]
.. إذاً.. مشثقّات الجذر: (غ، س، ق) تعني: الكدر وعدم الصفاء وعدم الرؤية في تناول ذلك الكدر، وهذا ما يتجلّى في قوله تعالى :
(مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسۡقَىٰ مِن مَّآءٖ صَدِيدٖ ١٦ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ) [إبراهيم: 16 – 17]
.. فذهاب الشفافية والصفاء والنقاء والفائدة وعدم رؤية ذلك، محمولٌ بدلالات الجذر (غ، س، ق).. ومن هنا نُدرك دلالات العبارة القرآنيّة (غَسَقِ ٱلَّيۡلِ) في قوله تعالى..
(أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودًا) [الإسراء: 78]
.. العبارة القرآنيّة: (إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ) تعني: إلى بداية دخول ظلام الليل (وهو المغرب)، وبداية سدُّ المناظر وذهاب النور والرؤية والحركة والمعاش، حيث غيبوبة الشفق الأبيض وبداية تراكم الظلمة واشتدادها..
.. فالقاسم المشترك لدلالات الجذر (غ، س، ق) في كتاب الله تعالى هو: الظلمة وسدُّ الرؤية، والكدر، والعكر، وعدم الصفاء، وذهاب النفع، وتوقّف حركة الفائدة والحياة..
.. وما نراه أنَّ كلمة (غَاسِقٍ) بصيغة اسم فاعل، لتصف القائم بأفعال دلالات الجذر (غ، س، ق)، وليس هذه الأفعال بعينها….. وكلمة (إِذَا) في قوله تعالى: (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) تحمل دلالة حتمية الوقوع، فالله تعالى يقول: (إِذَا) ولم يقل: (إن).. وكلمة (وَقَبَ) هي المشتق الوحيد للجذر (و، ق، ب) في كتاب الله تعالى..
.. من هنا نرى أنَّ الفعل الدنيء الفاسد الضار للغاسق حين (إِذَا) يحلُّ ويتجمّع ويفعل فعله الفاسد والمضر والحاجب للنور والرؤية، يكون قد (وَقَبَ)..
.. فقوله تعالى (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) يعني: ومن شرِّ الفاسد المُظلم العاصي الضار البعيد عن الحق، ومن أذيته، حينما يحلُّ فساده وظلمه وضرره وأذاه.. فالاستعاذة من شرِّ فساده وضرره وظلمه وأذيته حينما يحلّ ذلك ويتجمَّع ويفعل فعله..
.. والعلاقة بين صفة المُستعاذ به: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ) وبين فعل المستعاذ منه: (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) بيّنة.. فكلُّ أفعال الفساد والظلم والضرر والإيذاء التي يقوم بها الغاسق وحلولها وتجمّعها وإحاطتها بالمستعيذ، هي نتيجة تسخير الأسباب في عالم الامتحان هذا، تلك الأسباب التي تنتج بآلة الفلق التي ربّها الله تعالى (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)..
.. العنصر الثالث من عناصر المُستعاذ منه هو: (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ).. وكلمة (ٱلنَّفَّٰثَٰتِ) هي المشتقّ الوحيد للجذر: (ن، ف، ث) في كتاب الله تعالى.. والمعنى المُجرَّد لدلالات هذا الجذر اللغوي هو: التأثير في المنفوث فيه، معنويّاً أو ماديّاً، بغية التأثير عليه، ووضعه بحال يُريدها النافث.. بمعنى: بثُّ ما يريده النافث في ذات المنفوث فيه..
.. وما نراه أنَّ كلمة (ٱلنَّفَّٰثَٰتِ) هي جمع مؤنّث سالم لكلمة (النفّاثة)، على وزن (الفعّالة)، فورودها بهذه الصيغة، ومعرَّفة بأل التعريف: (ٱلنَّفَّٰثَٰتِ)، يصوِّر حالات ثابتة ومعروفة في كونها فعّالة في بث الشرِّ في العقد، فصيغة المؤنث المعرّفة بأل التعريف تصف النفوس المُظلمة التي تبثّ الضرر والفساد في العقد، أو الحالات الكونيّة التي تبثّ ذلك بكينونتها.. فالاستعاذة ليست من النفّاثات بعينها، وإنّما من شرِّ بثِّها في العقد..
.. وكلمة (ٱلۡعُقَدِ) هي من الجذر (ع، ق، د)، ودلالات هذا الجذر في كتاب الله تعالى تدور في إطار: الربط والثبات والرسوخ والتوكيد والعهد والميثاق..
.. فالعهود الثابتة المؤكَّدة المفروضة على الإنسان بقوة التزامه بها، تسمى عقوداً..
(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ) [المائدة: 1]
.. والأيمان المؤكَّدة والمُحكمة والموثّقة تسمّى أيماناً مُعقَّدة..
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَ) [المائدة: 89]
.. وعهد النكاح بتوثيقه وميثاقه الغليظ وربط طرفي عقد النكاح مع بعضهما بهذا الميثاق، يُسمّى (عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ)..
(وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُ) [البقرة: 235]
.. وربط اللسان وتوثيقه وحدّ حريته في الانطلاق في النطق، يُسمّى (عُقۡدَةَ)..
(وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةً مِّن لِّسَانِي ٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي) [طه: 27 – 28]
.. فكلُّ ما هو ثابت وراسخ من عهود أو أفكار أو عقائد أو ثوابت، تُسمَّى عقداً..
من هنا نرى أنَّ المستعاذ منه (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ) يعني: من شرِّ ما تبثّه النفوس (في الجانب المعنوي) أو الحالات الكونيّة (في الجانب المادّي) من شرِّ يهدف لتفكيك ما هو راسخ وثابت وقيِّم، سواء كان ذلك عهوداً ومواثيق (مع الله تعالى، أم بين البشر، أم بين الزوج والزوجة)، أم قيماً وأفكاراً وعقائد.. فكلُّ ما ينفث في سبيل تفكيك هذه العقد النبيلة وحلِّها لنشر الفوضى والانحلال والفساد مكانها، يأمر الله تعالى بالاستعاذة منه: (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ)..
والعلاقة بين المُستعاذ منه (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ) والمُستعاذ به (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ) بيّنة، فشقّ هذه العُقد وفرقها وحلها بغية الانتقال بها إلى حالة جديدة، ماهيّتها الانحلال من القيم والمبادئ والثوابت والعقائد، هو فلْق هذه العُقد بهدف نشر وجه الشرّ بذلك….. وهذه الأسباب التي تُستخدم في ذلك، يُسخّرها ربُّ الفلق سبحانه وتعالى بغية امتحان الإنسان في هذه الحياة الدنيا..
.. والاستعاذة ليست من النفّاثات في العقد، فالنفث في العقد له وجه خير.. الاستعاذة هي من النفث الشرّير في هذه العقد (وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ)..
.. العنصر الرابع من عناصر المُستعاذ منه هو: (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)
.. .. وما نراه أنَّ كلمتي: [[(حَاسِدٍ) ،، (حَسَدَ)]]، في هذه الآية الكريمة من الجذر (ح، س، د)، ودلالات هذه الجذر اللغوي تعني: تمنّي الحاسد زوال النعمة عن المحسود وأن تكون من نصيب الحاسد..
(وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّ) [البقرة: 109]
(أَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِ) [النساء: 54]
.. وهنا نرى كلمة (حَاسِدٍ) بصيغة اسم فاعل، وورود كلمة (إِذَا) وليس كلمة (إن)، بمعني: حين يحسد.. وصيغة العنصر الرابع من عناصر المُستعاذ منه تُشابه صيغة النصر الثاني: (وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ).. وبالتالي يكون معنى الآية الكريمة: (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ): ومن شرِّ من يريد زوال النعمة، حينما يُفعِّل حسده ويمارسه كضرر وسوء يريد إلحاقه بالمُستعيذ..
والعلاقة بين المُستعاذ منه: (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) والمُستعاذ به: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ) بيّنة، فالأسباب التي يستخدمها الحاسد حينما يجمع أمره لإيذاء المُستعيذ، مخلوقة لله تعالى، ويُسخّرها ربُّ الفلق سبحانه وتعالى بغية امتحان الإنسان في هذه الحياة الدنيا..
.. والاستعاذة ليست من الحاسد، فالحاسد كقيمة معنويّة سلبيّة لا يؤثّر شيئاً.. الاستعاذة هي من الشرِّ المتولّد عن فعل الحاسد وهمّه بإيذاء المُستعيذ: (وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)..
.. بعد هذا التفسير لهذه السورة الكريمة، بتنا نُدرك أكثر من قبل عظمة صياغة النصِّ القرآني.. فالمُستعاذ به في هذه السورة الكريمة هو عنصر واحد: (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)، وهو صفة الربوبيّة لله تعالى، والمُستعاذ منه هو أربعة عناصر: (مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ ٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).. وهذا أمرٌ طبيعيٌّ، فكون عناصر المُستعاذ منه كلُّها لها تعلُّقها بعالم الربوبيّة (عالم الخلق)، وهو عالم محسوس، كان المُستعاذ به هو عنصرٌ واحد هو (بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ)..
.. بينما لو نظرنا في سورة الناس التالية مباشرة، لرأينا عكس ذلك، لرأينا أنَّ عناصر المُستعاذ به ثلاثة (بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ)، بينما المُستعاذ منه هو عنصر واحد (ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ).. وسنبيّن ذلك بالتفصيل – إن شاء الله تعالى – في تفسير سورة الناس..
(قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ) [الناس: 1 – 6]